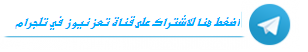التقسيم في #السعودية مسألة وقت فقط
في خطابه ليلة العاشر من محرم، أورد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في معرض حديثه عن خطورة مشروع انفصال إقليم كردستان رسائل بالغة الأهمية لدول المنطقة عندما قال إن “قضية كردستان لا تتعلّق باستفتاء أو بتقرير مصير بل بتقسيم المنطقة على أسس عرقية”. السيد اختار أن يفصّل أكثر متناولًا ارتدادات الخطوة الكردية عندما وجّه تحذيرًا مباشرًا للسعودية موضحًا أن “انفصال كردستان إن حصل سيؤدي إلى تقسيم السعودية، وهي من أكثر دول المنطقة المؤهّلة للتقسيم”.
كان بإمكان سماحته أن يكتفي بتحذير دول المنطقة بشكل عام من خطورة الخطوة الكردية على مستقبل المنطقة بشكل عام، لكن تسمية السعودية بالاسم وقوله إنها مؤهلة للتقسيم يستدعي من المتابعين التوقّف للبحث في المؤشرات الباعثة على إمكان تحقّق ذلك.
لطالما خرجت أصوات مشكّكة بأصل وجود فكرة تقسيم المنطقة على أسس قومية ودينية ومذهبية قديمة. الإصدارات والكتابات في هذا الصدد كثيرة، ولعلّ أبرزها ما تبنّاه المفكّر الصهيوني البريطاني الشهير برنارد لويس في ما سمّاه “الشرق الأوسط الجديد”.
عرض لويس في كثير من كتبه منذ السبعينات تقسيم دول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا الى دويلات على أسس دينية وعرقية، وطبعًا أغلب ما تنبّأ فيه ضمن رؤيته التي أخرجها عام 1994 للعلن في كتابه “The Shaping of the Modern Middle East” https://archive.org/details/shapingofmodern00lewi فشل حتى الآن، ما عدا عملية تقسيم السودان التي نجحت عام 2010. يقول المفكّر والمؤرخ المصري الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيري في مقال نشره عام 2006 حمل عنوان ” الشرق الأوسط الجديد في التصور الأمريكي والصهيوني”
بكثير من الإطمئنان يمكن القول إن الاستراتيجية الغربية تجاه العالم الإسلامي منذ منتصف القرن التاسع عشر تنطلق من الإيمان بضرورة تقسيم العالم العربي والإسلامي إلى دويلات إثنية ودينية مختلفة، حتى يسهل التحكم فيه”. يسرد المسيري في المقال بأسلوب تهكّمي بعضًا من كتابات منظّري المحافظين الجدد في واشنطن والصهاينة في كيان العدو لفكرة تقسيم الدول العربية استنادًا الى فشلهم في تحقيق الخطوة الأولى من المشروع في تموز 2006، عندما هزمت المقاومة العدو في جنوب لبنان، وهو ما يكرره السيد نصر الله في أغلب خطبه عند الحديث عن إنجازات المقاومة”.
السعودية في المخططات السابقة للتقسيم
في الخريطة المستوحاة من مخطط برنارد لويس التقسيمي تظهر المملكة السعودية وقد تجزّأت إلى ثلاث دويلات: الأولى في الشرق للشيعة العرب، والثانية في الغرب تحت اسم “الدولة الاسلامية المقدسة”، والثالثة في المنتصف تحت اسم “دولة السعوديين المستقلة”، بالاضافة الى اقتطاع جزء من الاراضي الشمالية الغربية (تبوك) وإلحاقها بالأردن، واقتطاع كل من مناطق جيزان ونجران وعسير في الجنوب وإعادتها لليمن.
في الأول من حزيران عام 2006 نشر ضابط أمريكي متقاعد يدعى “رالف بيترز” في مجلة القوات المسلحة Armed Forces Journal مقالًا تحت عنوان “حدود الدم” http://armedforcesjournal.com/blood-borders/ .
المقال يتضمّن مخططًا مشابهًا لرؤية لويس، لكن يشمل بعض التفاصيل والشرح الأكثر وضوحًا. يعتبر الضابط الأمريكي أن السعوديين سيُعانون من خسارتهم للكثير من أراضيهم تمامًا كما باكستان، ويضيف على نحو خاص أن آل سعود يسيطرون على الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ويتعاملون مع المقدسات فيهما بطريقة إقطاعية، الأمر الذي تسبّب بمشاكل كبيرة لمسلمي العالم بالنظر الى العقيدة الوهابية التي يفرضونها على المسلمين.
ويعرض “بيترز” فكرة استقلال الحجاز بمقدساته عن سلطة السعوديين على أن يُدار من قبل مجلس دوري يمثّل مختلف المدارس الاسلامية حول العالم بما يشبه “فاتيكان إسلامي”. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية الغنية بالنفط، فيشير “بيترز” الى وجوب أن يحكمها سكّانها الأصليون من الشيعة، فيما تتمدّد حدود الأردن لتشمل جزءاً من الشمال السعودي، أمّا الجنوب فسوف يذهب جزء منه لليمن.
نقاط القوة المتحوّلة لنقاط ضعف
صحيح أن أغلب مخططات تقسيم منطقتنا التي وضعها الغربيون لا تشرح بالتفصيل المملّ كيفية حصولها، لكن يمكن استنتاج حيثياتها بالمنطق. أولًا من الطبيعي أن أية دولة تملك قوة ممانعة من الداخل سوف يصعب تقسيمها، والحديث هنا عن القوة المكتسبة من الإرادة الشعبية والمخزون الوطني الذي على أساسه تتشكّل القوة المسلّحة الكفيلة بإجهاض محاولات التقسيم مدعومة بالإرادة الشعبية. في حالة السعودية، ليس هناك انتخاباتٌ ولا نظامٌ ديمقراطيٌ يُسهم في إيصال الحاكم الى سدة الحكم، بل حكم رجل واحد مطلق الصلاحيات، يحدّد للرعية من يرثه من بعده، في ظل غياب أية سلطة تراقب عمل الحاكم. يمكن القول إن النظام السعودي يرتكز على ثلاثة عوامل لطالما حصّنت حكمه وساهمت في استمراريته: الحاضنة التاريخية للنظام، تماسك العائلة المالكة، والحماية الأمريكية.
الحاضنة التاريخية للنظام
في الواقع، حتى الحاضنة التاريخية للنظام في منطقة نجد المؤلّفة من القبائل لم تختر العائلة السعودية وفق نظام ديمقراطي شوَري، بحكم أن آل سعود في دولهم الثلاث أعملوا السيف في رقاب أغلب أبناء قبائل هذه الحاضنة، حتى توصلوا مع بروز نجم عبد العزيز بداية القرن العشرين الى صيغة تتمثّل بعقد غير مكتوب، يقوم على مبايعة الملك بمباركة المؤسسة الدينية مقابل مكاسب انتفاعية تحظى بها هذه القبائل.
خاض أبناء هذه القبائل (جيش اخوان من طاع الله) أغلب حروب عبد العزيز للسيطرة على مناطق واسعة من أراضي شبه الجزيرة العربية وكانت تحصل على حصصها من الغنائم. حتى أنه قبل اكتشاف النفط، واجه عبد العزيز مشكلة كبيرة تتمثّل في عدم استطاعته تأمين أموال وأسلحة لهذه القبائل التي قامت دولته على أكتافها، الأمر الذي كان يقلقه لناحية تأثّر منظومة الولاء لديها.
لاحقًا مع اكتشاف النفط وطفرته، دمج آل سعود هذه القبائل النجدية في مؤسسات الحكم وعيّنوا أبناءها في مناصب وزارية وفي الإدارات الرسمية، وكانوا ولا يزالون يحظون بحصّة الأسد في التعيينات الإدارية والمناصب في الوزارات والمؤسسة العسكرية ( الحرس الوطني يتألّف من ألوية تتشكل من أبناء هذه القبائل). تمتّعت هذه الحاضنة بالمزايا التي حُرم منها أغلب أبناء المناطق الأخرى في شرق المملكة وغربها وجنوبها، حتى ترسّخت قاعدة تكاد تكون من المسلّمات، أن أبناء الحجاز والمنطقة الشرقية ومناطق الجنوب في عسير، جيزان ونجران هم مواطنون من الدرجة الثانية والثالثة. هذه القاعدة انسحبت على شعور بالظلم لدى أبناء هذه المناطق وهم مجبرون على الطاعة كون أي حراك مطلبي يتم التعامل معه بسياسة القبضة الحديدية بحكم قوة النظام داخليًا (حتى حين).
بعد وفاة الملك السابق عبد الله، استلم الملك سلمان الحكم وانتهج سياسة ارتدت على النظام فشلًا، سواء على مستوى الحروب الخاسرة في الإقليم، وسياسة إغراق السوق النفطية بالإنتاج، ما أدى لهبوط أسعار النفط (رافد خزينة الدولة بنسبة 85%)، وتراجع الاقتصاد ووقوعه بالعجز. عامان ونصف العام هي مدة حكم سلمان حتى الآن، فترة شهدت إلغاءً للكثير من الامتيازات والعطاءات والمكافآت التي كان يحظى بها أبناء حاضنة النظام بالدرجة الأولى، مع تراجع تأثير رجال السلطة الدينية في المجتمع ككلّ وفي مناطق نفوذ النظام في نجد (بسبب السياسة التي انتهجها محمد نجل الملك للوصول لولاية العهد).
المؤشرات التي تشي بتحسّن الاقتصاد في المستقبل المنظور تكاد تكون ضئيلة في ظل استمرار تدهور أرقام النمو وارتفاع مستوى الاستدانة لسدّ العجز، كل هذا سينعكس تأثيره على حاضنة النظام التي بدأت تتأثّر مصالحها خصوصًا مع بروز شحن قَبَلي على خلفية الأزمة بين السعودية وقطر التي طالت الجانب القَبَلي مع تصاعد التحريض المتبادل بين النظامين من هذه البوابة.
تماسك العائلة المالكة
لطالما حرص أبناء عبد العزيز على إظهار علامات التوافق والوحدة فيما بينهم حتى في عزّ أزماتهم. فخلال الأزمة التي وقعت بين الملك سعود وأخيه فيصل بداية الستينات، حرصوا على أن يصوّروا لشعبهم ان إجماعهم خلف فيصل هو الذي حسم الخلاف وأفضى الى تنحية سعود.
ولاحقًا مع تصاعد الخلاف بين عبد الله والسديريين، كانوا يحرصون على أن لا تتسرّب للإعلام أية معلومات عن خلافاتهم ومشاكلهم مع بعضهم البعض، غير أن بعض الدبلوماسيين الأمريكيين كانوا يسرّبون بعضًا من قصص صراعهم ولا سيما في جزئية تقديم كل أمير أحد أبنائه لترقيته الى سلّم العرش. لعل من حظ سلمان ونجله أن سلطان ونايف توفيا قبل الملك عبد الله، وخصوصًا في ظلّ تردّد عبد الله عن تصعيد إبنه متعب في حياته. على الرغم من أن سلمان حاول أن يُخرج سيناريو مثيرًا لتصعيد ابنه الى ولاية العهد لخلافته بطريقة التفافية، إلا أن الأحداث التي تلت إقصاء مقرن في نيسان 2015 ثم عزل محمد بن نايف في حزيران 2017، تؤكّد بما لا شك فيه ان الرجل كان يحاول استيعاب رفض داخل العائلة وردات فعل لا تزال غير معلومة النتائج.
من المسلّم به أن الأسرة الحاكمة في السعودية لم تعد هي نفسها قبل عقود. هناك أنباء تخرج كل فترة عن اعتقال أمير أو وضع آخر قيد الإقامة الجبرية، أو قرب عزل وزير الحرس الوطني متعب بن عبد الله من منصبه وإلحاق وزارته بوزارة الدفاع، والأسباب حكمًا لا تتعلّق بإجراءات عقابية لهؤلاء الأمراء على خلفية عصيانهم اوامر ملكية، بل من الواضح أنها عمليات استباقية نتيجة عدم وجود ثقة بهم لناحية حياكتهم لمخططات تآمرية على وليّ العهد القادم الى العرش. وبذلك يكون الملك السعودي قد وفّر الأرضية الملائمة لنزاعات مستقبلية بين أمراء العائلة الحاكمة، وبروز تحالفات سرّية قد تسعى لانقلابات في المناطق أو أقلّه إحداث قلاقل تستدعي إعلان حالة الطوارئ داخل العائلة، في ظل قوة مركزية في الرياض آخذة بالأفول مع استمرار تدهور الإقتصاد وتقليص مخصّصات الأمراء والعطاءات الممنوحة لهم.
الحماية الأمريكية
في أكثر من خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، كرّر في معرض تناوله العلاقات مع دول الخليج أن “هذه الدول لن تستمر من دون حمايتنا”، وهو المصرّ منذ الثمانينات على تدفيع السعودية أثمان الحماية التي يعتبر منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي ان بلاده تقدّمها للرياض بالمجان. جُنّ جنون السعوديين مما جاء في مقابلة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع مجلة The Atlantic في آذار 2016، التي ألمح فيها إلى أنه لا يمكنه أن يعتبر السعودية حليفًا وأن “على الرياض أن تكفّ عن سياسة الركوب بالمجان وتعتاد على حلّ مشاكلها بنفسها وتقلع عن الطلب منّا أن نخوض حروبها بالنيابة عنها”.
بعدها بفترة وجيزة، نشر رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تركي الفيصل مقالًا لعنوان “لا .. يا سيد أوباما عبّر فيه عن الخوف الذي اعترى آل سعود من فكرة تخلّي واشنطن عن العلاقة معهم، بالتزامن مع مناقشة أعضاء الكونغرس إقرار قانون “جاستا” الذي يستهدف الرياض على خلفية تورّطها في هجمات 11 أيلول 2001.
هذا التخوّف عكسته الاندفاعة السعودية باتجاه ترامب مع فوزه في انتخابات الرئاسة وتسلّمه منصبه. استجدت الرياض رضا ترامب لأسباب عديدة، بينها لأن هناك اعتقادًا نما في السنة الأخيرة من فترة حكم باراك أوباما لدى حاضنة النظام (طبقة رجال الأعمال النجديين المرتبطين بالحكم انتفاعيًا مع قبائلهم، والمتكسّبين في البلاط والوزارات والمناصب في قصور الأمراء) أن واشنطن قررت التخلّي عن العائلة المالكة السعودية.. اتّساع هذا الاعتقاد وترسّخه من شأنه أن يُضعف ركنًا أساسيًا يستقوي النظام به لاستمرار تماسكه داخليًا، وهذه البيئة الحاضنة (الذي ذُكرَت أعلاه) تعلم جيدًا أنّ السلطة في الرياض لا يمكن أن تستمر في الحكم إذا ما قرّرت واشنطن أنّ صلاحيتها قد انتهت. لكن تكتمل الدوامة التي حاصر النظام فيها نفسه عندما يتبيّن أن الملك ونجله قرّرا أن يضعا بيض مملكتهما كلّه في سلة ترامب، وهذا مأزق كبير عنوانه تسليم مقدّرات الدولة ورصيدها للأمريكي الذي تسلّم جزءًا منها وفي طريقه لتسلّم الباقي مع مرور سنوات رؤية محمد بن سلمان المسماة 2030.
إن شركة أرامكو التي لطالما تغنّى آل سعود بامتلاك قرارها (وهي التي تدرّ على خزينة الدولة أكثر من ثلاث أرباع ميزانيتها)، على وشك ان تُطرح للبيع عام 2018 في اكتتاب سيكون للمستثمر الأمريكي حصة الأسد فيه، وبالتالي فقدان السيطرة على قراراتها مع طرح مزيد من الأسهم للبيع في المرحلة القادمة بعد اكتتابها الأولي. وهنا يبرز السؤال: إذا ما ضحّى آل سعود ببقرتهم المقدّسة ” أرامكو”، ماذا سيتبقى لهم من أوراق صمود في وجه ابتلاع الأمريكيين لاقتصادهم الذي يستمدّون منه مصدر القوة داخليًا ويغدقون منه خارجيًا؟
تبدو السعودية اليوم وكأنها سلّمت لقدرها الذي اختارته لنفسها مع إصرارها على إدمان الارتماء بالحضن الأمريكي بعد البريطاني. كان للرياض فرص في الماضي لأن تتحرّر من التبعية للأمريكيين وتدشن سياسة ذاتية لا تقوم على دور وظيفي لواشنطن. يظهر للمتابع عن قرب أن الرياض اختارت الانغماس في المشاريع الأمريكية في المنطقة أكثر من أي وقت مضى، وهي تسير على قدميها عارفة بمصيرها المحتّم، لأنها بكل بساطة قد تكون وصلت إلى نقطة اللاعودة. تدعم بالشراكة مع الصهاينة مشروع تقسيم العراق نكاية بطهران بالدرجة الاولى، ثم أنقرة بالدرجة الثانية، وتسعى لقيادة مشروع تصفية قضية فلسطين وإظهار علاقتها بكيان العدو، ربما لاعتقادها بأن علاقتها بـ”تل أبيب” قد تشفع لها وتؤخّر مخطط التقسيم القادم إليها.