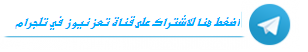الملف الشيعي … آفاق التسوية والانفجار
لم يهدأ الحراك السياسي في المنطقة الشرقية المتربعة على آبار النفط, شريان الاقتصاد السعودي, منذ سيطرة الملك عبدالعزيز بن سعود على أراضي القطيف والأحساء بين عامي 1912/1913 غير أن الانتفاضة المطلبية التي انفجرت فبراير 2011 بزخم جماهيري غير مسبوق هي الأطول عمراً والأعمق تأثيراً والأوسع انتشاراً ولا تزال تشظياتها وتموجاتها السياسية والاجتماعية والأمنية تتفاعل باضطراد حتى اللحظة رغم مرور 5 أعوام على اشتعال شرارتها الأولى.
الانتفاضة جذور ومطالب
لا تولد ثورات الشعوب وانتفاضاتهم بلا أسباب ومبررات، فالبركان الجماهيري الغاضب انما ينفجر بعد تكامل المقتضيات والعوامل التي تدفعه للجوء إلى الشارع كخيار أخير ووحيد, بعد انسداد أفق الخيارات والحلول الأخرى التي غالباً ما تكون أقل كلفة بشرياً ومادياً وأمنياً. فالشعوب تعلم وتدرك بشكل مبكر الفاتورة الباهضة للثورة والانتفاضة على الأنظمة الاستبدادية الحاكمة بمنطق الحديد والنار، لكنها تصرّ على اقتحام الميادين والشوارع وتقديم التضحيات الجسام من الدماء والأوراح والممتلكات حين تفقد الثقة في كل البدائل الممكنة والتي سبق لها أن خاضت غمارها طوال سنين متعاقبة دون إحراز النتائج المرجوة، فلا يعود لديها أمل في شيء غير السعي لقلب المعادلة المفروضة عليها بإزاحة الصمت والتكتم الذي يفرضه النظام على الشعب ويحمي به ممارساته القمعية ضد المطالبين بالحقوق والحريات والعدالة.
في الأحساء والقطيف يُشكل السكان الأصليون غالبية شيعية, رغم لجوء النظام السعودي إلى سياسات وخطط التغيير الديموغرافي، وتختزن الذاكرة الشيعية تاريخاً ممتداً لقرن كامل من الحراك والنشاط السياسي والمطلبي والانتفاضات الشعبية ضد خطط التهميش السياسي والحرمان الاقتصادي والتنموي والإقصاء الإداري وقمع الهوية المذهبية والثقافية، وقد راكم المجتمع الشيعي طوال هذه العقود خبرات وتجارب صقلت وعيه وكفاءاته السياسية وكونت حواضن لانتاج النخب الفاعلة سياسياً، في حين اكتفى النظام باللجوء وبشكل مستمر إلى مواجهة الحراك السياسي الشيعي أياً كان مستواه ومهما تنوعت وسائله وبغض النظر عن ماهية وحجم مطالبه وشعاراته ولغة خطابه عبر الحلول الأمنية العنيفة ومحاولات الإلتفاف على المطالب الشعبية بتسكين النفوس عبر سيل الوعود التي سرعان ما تتبخر حالما يستشعر النظام أنه استعاد سيطرته على الشارع كما حدث في أعقاب انتفاضة العام 1400/1979 أو على القوى المعارضة كما هو الحال في أعقاب الاتفاق الذي أبرمه الملك فهد مع المعارضة الشيعية بعد الحوار بين عامي 1992/1994، فضلاً عن استهانة النظام واستهتاره بالعرائض المطلبية التي قدمها وجهاء الشيعة في القطيف والأحساء طوال 100 عام من عمر المملكة حيث واجههم الملوك والأمراء بالمماطلات والتسويف وتعليق الاستجابة على الظروف والزمن وإن حدث تجاوب مع بعض تلك المطالب فيبقى محصوراً ومحدوداً في إطار ضيق من التلبية الجزئية لبعض الحاجات الخدمية الملحة كتعبيد طريق أو بناء مستشقى!!
لا شك أن أحداث ما عُرف بالربيع العربي ساهمت بشكل كبير في تهيئة المناخ لانفجار الانتفاضة الشيعية في القطيف والأحساء، لكن الحقيقة الأهم بالنسبة للمراقبين السياسيين المتخصصين في شؤون المملكة هو أن “المنطقة الشرقية” وبعكس بقية المناطق كانت تتوفر على العوامل والمقتضيات ومهيأة لاستقبال شرارة التفجير التي تلقفها الشبان والنخب السياسية والدينية والاجتماعية رجالاً ونساء على حدٍ سواء فوجدنا الشوارع تصطخب وتموج بمئات الآلاف من المتظاهرين ومن مختلف الأعمار والتوجهات والفئات والمستويات والتيارات وكلها تنادي بذات المطالب والشعارات.
بدأت التظاهرات ببضعة آلاف وفي رقعة جغرافية محدودة، رُفعت خلالها مطالب واضحة، محددة، واقعية، وغير مكلفة سياسياً, أي لا تشكل كسراً لإرادة وهيبة النظام السياسي أو السلطة الأمنية، تلخصت في اطلاق سراح 9 معتقلين قضوا في السجون حتى ذلك الحين 16 سنوات دون تهم محددة أو محاكمات، اضافة لشعارات عبرت عن رفض سياسات وممارسات التمييز الطائفي والاساءات المذهبية للشيعة في المناهج التعليمية والدوائر الرسمية والاعلام المحلي.
تعنت النظام ولجأ لمطاردة المتظاهرين وشنّ حملة اعتقالات شملت العشرات، وسرعان ما اتسعت رقعة التظاهرات من القطيف إلى الأحساء، وتصاعدت أعداد المشاركين فيها، وتنوعت وتجذرت الشعارات والمطالب، ودعم العلماء الشيعة من على منابر المساجد مطالب المتظاهرين، ما سبب صدمة للسلطة السياسية والأجهزة الأمنية فراحت تعمل في وقت متزامن في اتجاهات متعددة لم تختلف ولم تتجاوز عقليتها في المعالجات الأمنية والالتفاف على المطالب الشعبية، فاستدعت الوجهاء وعلماء الدين وطالبتهم بتهدئة الجمهور ودعوته للتوقف عن التظاهر، غير أن محاولة هؤلاء باءت بالفشل خصوصاً وأنها تزامنت مع دفع السلطة بفرق قوات الطوارئ والمهمات الخاصة إلى الشوارع ومنحهم صلاحية اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والمارة فسقط أول شهيد الشاب ناصر المحيشي أثناء عودته من مقر دراسته في المعهد الثانوي الصناعي مساء الأحد 20 نوفمبر2011، كما لجأت السلطة إلى فرض طوق أمني على المنطقة بكاملها عبر عشرات الحواجز الأمنية المدججة بالسلاح والتي انتشرت على امتداد محيط المدن والبلدات، والشوراع الرئيسية المؤدية الى المحافظة، ما ساهم في خنق الحركة المرورية ورفع مستوى الاحتقان والضجر جرّاء تعطيل مصالح المواطنين وتأخير اسعاف المرضى.. الخ.
وعلى عكس ما خططت له السلطة واستهدفته من خلال التصعيد الدموي الذي راح ضحيته 3 شبان خلال يومي 20 و21 نوفمبر 2011 حيث قتل برصاص القناصة الشهيدان علي الفلفل وعلي آل قريريص في تظاهرة غاضبة طالبت بتسليم جثمان الشهيد المحيشي، تصاعد الغضب وانفجرت كل شوارع القطيف وقراها بالتظاهرات والشعارات المناوئة للنظام والأسرة المالكة وأحرقت صور الملك عبدالله والأمراء سلطان ونايف تعبيراً عن تجذر المطالب الشعبية والاتجاه إلى رفض كل ما يمتّ إلى النظام بصلة.
لم يعد النظام في نظر المتظاهرين الشيعة هو فقط السلطة الظالمة التي تحرمهم حقوقهم وتصادر حرياتهم وتمارس التمييز الطائفي والاقصاء والتهميش السياسي بحقهم، بل أصبح هو السلطة التي تقتل وتعتقل وتعذب شبابهم، وهي رسالة قرأ الشيعة مضامينها ومدلولاتها الكاشفة عن إصرار النظام على التمسك بسياساته في التنكر للمطالب الشيعية.
هكذا راح المتظاهرون يرفعون سقف مطالبهم إلى تلبية التطلعات السياسية والاستحقاقات المؤجلة، في رد مباشر على تصعيد السلطة للعنف، وبدا الموقف ملتهباً وأنه يسير نحو نقطة اللاعودة، ومع تتابع قافلة الشهداء والجرحى والمعتقلين، أكدت قيادات الانتفاضة في الداخل والخارج وعبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنابر الخطابة والتواصل الاجتماعي تمسّكها بتحقيق المطالب في المشاركة السياسية والادارة المحلية لشؤون المنطقة وإقرار الخطط التنموية الشاملة للمناطق الشيعية التي استثنيت دائماً وطوال 7 عقود من خطط التنمية والتطوير والإعمار، كما تمسك المتظاهرون بحق القصاص لدماء الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن اصدار قرارات سفك الدماء، واطلاق سراح كافة السجناء السياسيين سنة وشيعة.
وقابلت السلطة التصعيد الشعبي لمروحة المطالب والشعارات بعنف أكثر دموية فدفعت بالمدرعات إلى الشوراع والأحياء السكنية وراحت أعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين تتزايد فيما اكتفت السلطة باتهام مسلحين مندسين وسط المتظاهرين باطلاق الرصاص، الأمر الذي كذبه المتظاهرون عبر توثيقهم للحوادث بمقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، ما دفع القوات الأمنية إلى استهداف المصورين واغتيالهم بهدف منع التوثيق والحيلولة دون توافر أدلة تفضح عنف السلطة وخططها الأمنية، ومن بين الشهداء المصورين الذين كانت الكاميرا القاسم المشترك بينهم: علي الفلفل، أكبر الشاخوري، زهير السعيد، وحسين الفرج.
وبدا واضحاً أن المتظاهرين مثلوا الصوت المسموع وحملة راية المطالب التي نادى بها الشيعة في الشرقية طوال عقود حكم النظام السعودي، الأمر الذي كان يفرض على النظام والأسرة المالكة أن تصغي له جيداً وأن تتفحص مدياته وآفاقه بعين السياسي المسؤول الحريص على مصلحة الوطن، بعيداً عن عقلية التعنت وتصلب المواقف ورفض الاستجابة للمطالب بذريعة أن السلطة هي صاحبة اليد العليا وهي التي تفرض إرادتها على الشعب، الذي عليه أن ينصاع دائماً لقرارات السلطة ورغبات الأمراء.. وحتى حين أراد النظام التظاهر بالعقلانية والتجاوب مع مطالب المتظاهرين لجأ إلى تشكيل قوى محلية كشهود زور وحملة رسائل كاذبة من المقربين من النظام وغير المقبولين لدى المجتمع المحلي كونهم لا يمثلون نبض الجماهير وتطلعاتهم، وبذلك أخفق أمير المنطقة الشرقية محمد بن فهد ـ قبل عزله في 14 يناير 2013 ـ في التقاط جذور وحقيقة الاحتجاجات كما أخفق خلفه سعود بن نايف وشقيقه محمد بن نايف وزير الداخلية في قراءة عمق الانتفاضة وجديتها وقوة الدعم الأهلي الذي تحضى به مطالب المتظاهرين.
ولجأ النظام ضمن خطط محاصرة المتظاهرين إلى وصمهم بالخيانة الوطنية والعمالة إلى الخارج والارتماء في حضن ايران وأنهم ينفذون أجندة فارسية مجوسية.. الخ وظلّت هذه الاسطوانة تستعاد بشكل مستمر عبر مختلف وسائل الاعلام الرسمية وفي شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى أن اندلعت الأزمة الأخيرة مع دولة قطر, وسرعان ما وجدنا الاتهامات المتتابعة بدعم الدوحة إلى المحتجين في القطيف وتمويلهم وتدريبهم وما أشبه من اتهامات، فالمهم عند النظام أن يدفع بالتجييش الطائفي ضد شيعة القطيف والأحساء إلى مدياته القصوى ولا يهمه ما هي الوسيلة ولا الآثار المستقبلية التي قد تترتب عليها.
فالاتهام بالخيانة والارتباط بالخارج، أو الترويج أن الشيعة أقلية، لا يغير الحقائق على الأرض، فالشيعة كما غيرهم من فئات الشعب في نجد والحجاز وبقية مناطق المملكة كلهم أقليات فلا توجد في المملكة أغلبية متفوقة، فالنظام الحاكم نفسه ينتمي إلى أقلية نجدية وهابية، كما أن اتهام الشيعة بالعمالة للخارج وتحصيل الدعم من قوى أجنبية وهو الاتهام الذي سبق أن وصم النظام به قيادات وكوادر حسم وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين السنة.. هذا الاتهام الرخيص والمعلب لا يغير حقيقة أن الشيعة كما المعارضين السنة هم أصحاب مطالب مشروعة يرفض النظام والأسرة المالكة الإصغاء إليهم وتلبية مطالبهم.
ويصر النظام اليوم وبعد استبعاد محمد بن نايف عن دائرة القرار السياسي والأمني على تكرار الخطأ الفادح نفسه باللجوء الى التصعيد الأمني والعسكري ضد بؤر الاحتجاج في المناطق الأكثر سخونة والأشد عصياناً وتمرداً, دون أن يُمعن التفكير في سبل جادة وحلول فعالة لسحب فتيل الغضب الشيعي، فسياسة العصا الغليظة حتى وإن شلّت القوى المعارضة لفترة من الزمن فإنها تعمق جذور انبعاثها مجدداً وفي الغالب بشكل أكثر راديكالية.
ما ينبغي التأكيد عليه هنا أن “انتفاضة الكرامة” كما درج على تسميتها شيعة المنطقة الشرقية ولدت من رحم معاناة ذات جذور ممتدة إلى لحظة تكوين المملكة وسيطرة بن سعود على المناطق الشيعية في القطيف والأحساء، ويظهر جلياً وبعيداً عن تصريحات رجالات الشيعة ورموزهم في الداخل المحكومين إلى معادلة أمنية تتهددهم كما غيرهم من النشطاء والمعارضين السنة، فإن الجلي أن للانتفاضة مطالب يجدها الشيعة تمثل استحقاقات تاريخية تأخرت السلطة كثيراً في تلبيتها، كما أنه لا يبدو بأن العنف الرسمي سيكسر إرادة الشبان الشيعة الذين تجاوزوا رموزهم المحليين وقفزوا على كافة نداءات الخضوع للسلطة، حتى بتنا وكأننا أمام كتلة ثورية قررت خوض المعركة المصيرية حتى نهايتها وبحسب تعبير كوادر الانتفاضة أنفسهم “أما النصر أو الشهادة”! فهل تملك السلطة خيارات أخرى لمعالجة الملف الشيعي دون سفك مزيد من الدماء؟ وهل يمكنها نزع مبررات الانتفاضة؟ هذا ما سنحاول تبينه في المحور التالي.
السبيل إلى الاستقرار
حين نقترب من المجتمع الشيعي في “الشرقية” ونتفحص خارطته وموازين القوى فيه سوف نكتشف كيف وكم غيرت “انتفاضة الكرامة” المعادلات السياسية والمعطيات الاجتماعية والأمنية، فقد ساهمت في خلخلة قوى وإضعافها مقابل بناء مراكز قوى جديدة أو منح قوى كانت حتى وقت قريب مغمورة فنالت الفرصة للتمظهر على السطح والتمكن من التأثير في حركة الحياة العامة وموازين الاجتماع والسياسة، فالواقع اليوم في القطيف والأحساء لم يعد كما كان قبل 2011 ولا يمكن له أن يعود كما كان، هذه الحقيقة تفرض على صانع القرار السياسي في البلاد أن يدرك عمق التغيرات التي حدثت فدونها لن يقبض على مفاتيح المعالجات الفعالة القادرة على استئصال التوتر والقلق والاحتقان السياسي والأمني في الشارع الشيعي, خصوصاً ونحن نتحدث عن منطقة تُمثل عصب الحياة للمملكة ككيان حتى أننا نستطيع القول بأن مصير النظام الملكي الحاكم وأسرة بن سعود يتقرر ويرتبط عضوياً بمآلات تطورات الأوضاع في المناطق الشيعية، في ظرف اقليمي ودولي مضطرب وفي وقت تتجه أنظار دول إقليمية وعالمية عدة إلى منابع الطاقة وتترصد وتتربص لإعادة رسم خارطة المنطقة وتقاسم النفوذ فيها ما يجعل أفق التغييرات مفتوحاً على كل الاحتمالات.
النظام السعودي مضطر اليوم للتعامل بعقلية مختلفة، وأن يتسالم مع متغيرات الواقع، فلم يعد بإمكان أمراء نجد التعامل مع الشيعة في الشرقية بأنهم هامش وأن عليهم أن يقبلوا صاغرين ما يمليه وما يفرضه من قرارات وسياسات، فهو يتعامل مع أجيال مختلفة ولدت وعاشت في زمن مختلف وتتمتع بوعي وتطلعات وقدرات مختلفة، وهذا لا ينحصر في الشيعة وحدهم بل يشمل عموم الشعب السعودي في كل المناطق، لكنه لدى الشيعة في الشرقية أكثر نضجاً وتمظهراً وفعالية نظراً لعوامل ومسببات عدة ليس هنا مجال بحثها.
ولقد ساهمت سياسات وخطط النظام السعودي في تعاطيه مع الانتفاضة الشيعية في خلق مبررات إضافية وفرص جديدة لنمو القوى الشبابية المؤثرة وضمور وضعف القوى التقليدية التي كانت أكثر طواعية وأسهل انقياداً وأسرع استجابة وخضوعاً وقبولاً لما يقرره أمراء نجد، أما القوى الصاعدة اليوم فعينها على المطالب الجذرية وقد أبدت في سبيل تحقيقها الاستعداد للتمسك بها مهما بلغ حجم التضحيات.
ونلاحظ هنا أنه حين واصل النظام استخدام القوة والبطش بالمتظاهرين، نجحت بعض القوى الشبابية الصاعدة في تسليح نفسها بنحو أو آخر للرد على عنف السلطة والتصدي لعساكرها، الأمر الذي نتج عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف عناصر القوى الأمنية.
كما ساهمت سياسة الاعتقالات الواسعة في صفوف الشبان والكوادر الشيعية، وتعريضهم للتعذيب بهدف انتزاع الاعترافات ثم إحالتهم إلى محاكم شبه سرية وأمام قضاة وهابيين تشربوا الطائفية والحقد المذهبي على كل ما هو شيعي، ليواجهوا في النهاية أحكاماً قضائية أقل ما توصف به بحسب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية انها غير عادلة وغير مبررة ونتاج تسييس المحاكمات نظراً لارتهان جهاز القضاء برمته إلى وزارة الداخلية التي كانت تدير أيضاً هيئة التحقيق والادعاء العام قبل أن يتم تحويلها في 17 يونيو الماضي الى نيابة عامة وتلحق بالديوان الملكي.. هذا الوضع الذي انتهى إلى التلويح بسيف الاعدام بحق عشرات الشبان والكوادر الشيعة وانتهى في 2 يناير 2016 إلى تنفيذ حملة اعدامات أودت بحياة الرمز الشيعي البارز الشيخ نمر النمر و3 شبان آخرين ضمن 52 مواطناً لتتواصل باعدام 4 آخرين في 11 يوليو الجاري.. هذه الحملات الدموية ليس فقط لم تحقق للسلطة أهدافها في كسر شوكة الشيعة وارغامهم على الخضوع، بل هي مما ساهم في تعميق وترسيخ القناعة التامة في الوعي الشيعي عامة وكشف للرأي العام المحلي والدولي بأن الشيعة بالفعل يواجهون نظاماً طائفياً يستهدفهم على الهوية المذهبية ويستهين بقيمة الدم الشيعي، خصوصاً عند استحضار ممارسات قوات المهمات الخاصة في شوارع القطيف وأرجائها، حيث نفذت عمليات اغتيال وتصفيات دموية راح ضحيتها عشرات النشطاء والكوادر في الحركة الاحتجاجية، اضافة إلى طبيعة النهج الذي تتصرف وفقه وتتبعه القوات الأمنية المدججة بأعتى الأسلحة الفتاكة في بلدات وقرى محافظة القطيف وبالخصوص في العوامية ولجوئها إلى استخدام القنابل الحارقة وسط البيوت والمنازل بدء بالهجوم الشرس على منزل الناشط عباس المزرع فجر يوم 21 رمضان 1434 الموافق 29/7/2013 وهو مشهد تكرر لاحقاً وبصورة أبشع في عدة مداهمات قضى المُستَهدفون خلالها بالرصاص أو بالحرق والاختناق بالغازات السامة.
ولا يمكننا في هذا السياق أن نغفل عن متغيرات ميزان وخارطة القوى في المنطقة التي تشكلت في أعقاب سقوط نظام البعث الحاكم في العراق وصعود القوى الشيعية في المنطقة عموماً وبالخصوص في العراق ولبنان وسوريا وصولاً إلى تحولات المشهد اليمني فهذه المعادلات شئنا أم أبينا لها انعكاسات عميقة على الواقع الشيعي في الخليج كلّه وبالأخص في مناطق القطيف والأحساء والبحرين، ما يستدعي أن تأخذ السلطة السياسية في الرياض هذه التحولات بعين الاعتبار وهي تتعاطى مع ملف الشيعة في الداخل.. ولن ينفع هنا اللجوء إلى سياسات القمع من أجل امتصاص ومحاصرة الانعكاسات، فمثل هذا الإجراء لن تتعدى مفاعيله وآثاره المستوى النفسي لفترة زمنية محدودة دون أن ينجح في خلق وتشكيل جدار عزل وصد حقيقي لأن الارتباطات الاجتماعية وتشابك المصالح السياسية التي تربط بين سكان الأرخبيل الشيعي في المنطقة أكثر تجذراً من أن تقتلعها الحملات الأمنية مهما تعاظمت شراستها ودمويتها ومهما طال أمدها.
استناداً لهذه المعطيات مجتمعة فإن أمام النظام السعودي سبيل واضح لتجاوز مخاطر الاحتقان الحالي وانهاء ملف الأزمات الشيعية المتوالدة والمتراكمة منذ سنوات التأسيس مطلع القرن الماضي، وذلك بالعودة إلى جذور المشكلة والعمل على معالجتها فعلياً بعيداً عن الأفكار والخطط الالتفافية أو نوايا ترحيل المشاكل للأمام وتقطيع الوقت تعويلاً على الحلول التي تستجلبها المتغيرات السياسية المستقبلية, فمثل هذه المراهنات التي استمرت طوال قرن من الزمان لم تغير واقع الاحتقان السياسي ولم تزحزح مواقف الشيعة أو تضعفهم بل ساهمت في الدفع بهم للبحث عن آفاق ومصادر لبلورة قواهم المختلفة.
وبالنظر إلى تطورات الوضع الشيعي في القطيف والأحساء نستطيع الجزم أن سياسات التهميش والاقصاء بقدر ما آذت الشيعة وأدخلتهم معمعة الآلام والمعاناة فقد ساهمت أيضاً في بلورة قواهم الذاتية على أصعدة عدة ما جعلهم اليوم أقدر على التعاطي مع مطالبهم بشكل متقدم سياسياً ولوجستياً وقد رأينا كيف شكل الشيعة في غضون بضعة أسابيع لجان الحماية الأهلية في أعقاب استهداف مساجدهم وحسينياتهم من قبل الجماعات الإرهابية وعدم ثقتهم في جدية الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في توفير الحماية اللازمة إلى مناطقهم بعد اكتشاف أن جميع العناصر المشاركة بتنفيذ الهجمات ضد الشيعة هم من خريجي مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة وبعضهم لم يمضِ على الافراج عنه سوى بضعة أسابيع، ورغم اعلان السلطة عن اعتقال عشرات المتورطين في الهجمات إلا أنها لم تكشف عن نتائج التحقيقات ولم تقدم المتهمين للمحاكمات الأمر الذي أثار شكوك وحفيظة الشيعة..
وقد تكرر المشهد في صورة أبلغ تأثيراً وأكثر تنوعاً حين نجحت بلدة صغيرة كـ”العوامية” في الصمود أكثر من شهرين في وجه الحصار الخانق الذي فرضته السلطات عليها، وخلق أهالي البلدة أجهزة ولجاناً محلية تكفلت بتدبير وادارة شؤونهم المعيشية والخدمية كالصحة والغذاء والنظافة والاطفاء.. الخ.
في وجهة نظرنا فان الحل الحقيقي والسبيل إلى ضمان الاستقرار يتمثل في امتلاك شجاعة الاعتراف بأخطاء الماضي ومواجهة استحقاقات المرحلة بما تشمله من الحاجة للتكفير عن تركة الماضي بكل حمولاته السلبية والدخول في عملية سياسية قوامها المشاركة الحقيقية والفعلية وإنهاء سياسة الاقصاء والتهميش السياسي والأمني والاقتصادي والاداري، فلا يمكن لأي فئة من الشعب أن تمنح الولاء إلى سلطة سياسية تعاديها على قاعدة دينية مذهبية، كما لايمكن لأي فئة أن تثق وتطمئن إلى جهاز أمني يمنع القانون المعلن أو غير المعلن ويقصي القرار السياسي تلك الفئة من الانتساب إليه والترقي في مناصبه.. فكيف يمكن للشيعة أن يثقوا في سلطة تحرمهم حتى من منصب رئيس بلدية في محافظتهم؟! فضلاً عن اقصائهم من أجهزة الشرطة والمباحث وادارات السجون والجيش والحرس الوطني، والقضاء.. الخ. فالشيعة اليوم يدركون عمق السياسات التي استهدفت وجودهم بكل أبعاده وحاصرتهم في كل مناحي حياتهم اليومية، كما أنهم متنبهين دائماً وأبداً للموقع الاستراتيجي الذي تحتله مناطقهم على ساحل الخليج العربي وما تختزنه أراضيهم من ثروات اقتصادية هائلة شكلت ولا تزال عصب وشريان الحياة الاقتصادية لكل مناطق البلاد المترامية الأطراف.
ربما يتصور صانع القرار السياسي أننا نضخم من حجم القوى الشيعية المتطلعة للتغيير، غير أننا في الحقيقة نبني وجهة نظرنا استناداً إلى قراءة دقيقة لتحولات الواقع الشيعي المحلي، ونتلمس ما يختمر في العقول وما تختزنه النفوس مما لا يأمن ولا يجرأ قيادات ونخب الشيعة على التصريح به لكنهم يتبنونه ويعملون لأجله كل منهم على شاكلته وبطريقته، وهو ما يتطابق بنحو أو آخر مع الشعارات الراديكالية التي رفعها المتظاهرون الشيعة أنفسهم، ويكمن الفارق في لغة وأسلوب التعبير ليس أكثر!
وفي اعتقادنا أن السلطات السعودية لا تزال قادرة وامامها فرصة تاريخية لاستعادة السكان الشيعة إلى الصف الوطني قبل أن تفلت الأمور من أيدي الجميع، فتكاثر الضحايا سواء في المداهمات الدموية أو ساحات الاعدام مهما اجتهدت الأجهزة الأمنية ووسائل الاعلام المحلية على نعتهم بالارهابيين والمخربين سيبني جداراً ضخماً سيمنع فرص وإمكانات أي تلاقي مستقبلي، وسيضاعف همم الشيعة في السعي نحو الانفصال أو تقرير المصير أو طلب الحماية الدولية وحتى إلى اتهام النظام بممارسة الارهاب الطائفي والعنصرية المناطقية، وكما يراهن النظام على الزمن والتحولات السياسية، فإنه بامكان الشيعة أيضاً المراهنة على الزمن ومتغيرات السياسة الدولية والسعي لانشاء التحالفات ولنا في تجارب الاقليم والعالم عبر متكررة.
محمد المنصور